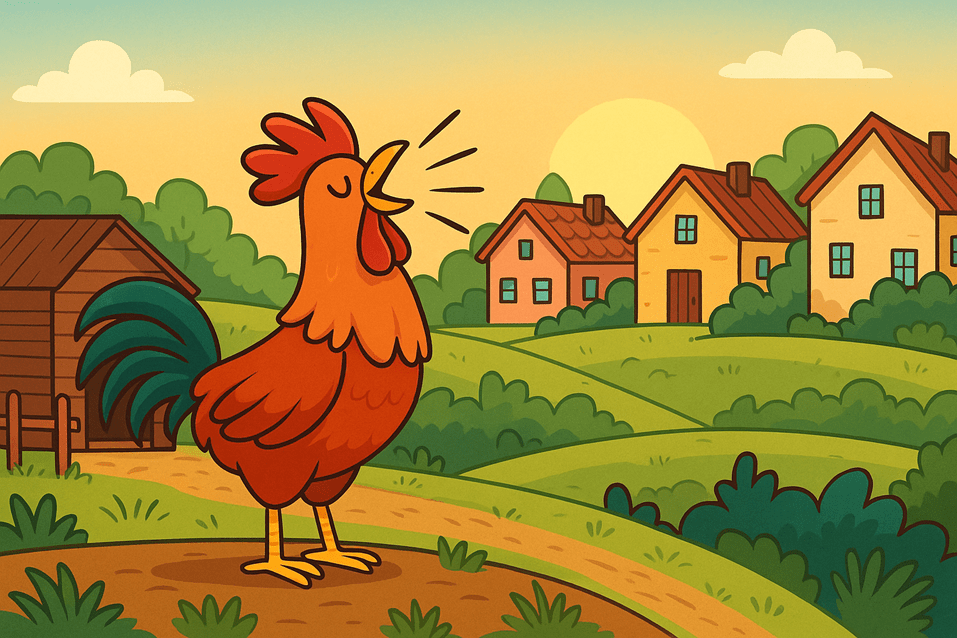
في قرية صغيرة هادئة تحيط بها الحقول الخضراء من كل جانب، عاش رجل يُدعى أبو خليل.
لم يكن أبو خليل شخصية معروفة كثيرًا بين الجيران، فقد كان يميل إلى العزلة، يعمل بصمت في مزرعته، ويربّي قطيعه الصغير من الدجاج.
لكن بين كل دجاجاته، كان هناك ديك مختلف، ديك قوي الصوت، جميل الريش، معتدل القامة، يطلق صيحته كل فجر في ساعة محددة كأنه ساعة منبّه لا تخطئ أبدًا.
كان صوت الديك يتردّد في أزقة القرية مع أول خيوط الفجر، فيوقظ الناس من نومهم، فينهض الفلاحون إلى حقولهم، وتستعد النساء لخبز أرغفة اليوم الجديد، ويتهيأ الأطفال للذهاب إلى مدارسهم.
صار صوت الديك عادة يومية، جزءًا من نظام حياتهم، حتى إنهم نسوا أن هناك ديكًا حقيقيًا يقف وراء تلك الصيحات.
كانوا يسمونه بينهم مازحين منبّه القرية.
الاعتماد على الديك
مضت الأيام والسنوات، وأصبح سكان القرية يضبطون ساعات حياتهم على صيحة الديك، حتى الذين امتلكوا ساعات حائط أو ساعات يدوية كانوا يثقون في صياحه أكثر من عقارب الساعات.
لم يسأل أحدهم قط: من يملك هذا الديك؟
أو أين يسكن صاحبه؟.
اكتفوا فقط بسماع صوته، والاعتماد عليه، وكأن الصوت ملكٌ مشاع للجميع.
أما أبو خليل، فكان يقف كل صباح عند باب كوخه الصغير، يبتسم حين يسمع صياح ديكه يتردّد بين البيوت، ولا يبوح لأحد أن هذا الديك له.
كان يرى في الأمر خدمة للقرية كلها، ولم يكن ينتظر شكرًا من أحد.
اليوم المختلف
وذات صباح، استيقظ أهل القرية على غير عادتهم… بل لم يستيقظوا أصلًا!
فالشمس ارتفعت، والضياء ملأ السماء، لكن لا صوت ولا أثر للديك.
نام الجميع أكثر مما ينبغي، وفاتهم أن يبدأوا يومهم في وقته.
الفلاحون تأخروا عن السقي والحصاد، فذبل بعض الزرع.
النسوة وجدن أن أرغفة الخبز لن تكون جاهزة قبل مجيء أطفال المدارس، فتأخر إفطارهم.
حتى الحلاق في السوق ضاق ذرعًا بالزبائن الذين تكدسوا عنده متأخرين عن عادتهم.
انتشر الغضب في القرية، وتساءل الناس:
أين ذهب الديك؟
كيف تجرأ أن يغيب؟
من المسؤول عن هذا الإهمال؟
لكن أحدًا لم يعرف بيت الديك، ولا صاحبه.
لم يعرفوا أن اسمه ديك أبو خليل، ولا أن صاحبه يعيش بينهم منذ سنوات.
الغضب على الغائب
اجتمع بعضهم في ساحة القرية، وبدأوا يلعنون الديك:
لقد تعودنا عليه، فتركنا في ورطة!
ما كان يجب أن نعتمد عليه!
حتى لو عاد غدًا، فلن نسامحه!
قال آخر ساخرًا:
لعل صاحبه باعه!
أي إنسان عاقل يربّي ديكًا كهذا ثم يحرمنا منه؟
لكن الحقيقة كانت أبسط وأقسى: أبو خليل رحل من القرية.
حمل ديكه معه إلى مكان آخر، حيث لم يعد يشعر أنه مُقدَّر أو حتى معروف.
كان يعيش بينهم كظل، وصوت ديكه يخدمهم كل صباح، لكن لم يلتفت إليه أحد ليسأله عن اسمه أو عن حياته.
الندم
بمرور الأيام، حاول الناس التعايش مع غياب صوت الديك.
اشترى بعضهم ساعات من السوق، وأخذ آخرون يضبطون منبّهات ميكانيكية، لكن شيئًا ما كان مفقودًا.
لم يكن صوت الحديد والجرس يشبه ذلك الصوت الحيّ الذي كان يملأ الفجر دفئًا وحياة.
صاروا يذكرون ديك أبو خليل الذي لم يعرفوا صاحبه قط بلهجة ندم:
لقد كنا نملك نعمة ولم نشعر بها.
كنا نسمع صوته ولا نقدّر قيمته.
رحل لأنه لم يجد مكانًا بيننا، وربما وجد من يقدّره أكثر في قرية أخرى.
في مكان آخر
أما أبو خليل، فقد وصل إلى قرية بعيدة.
هناك، حين صاح ديكه في الصباح الأول، خرج بعض أهل القرية الجديدة يبحثون عنه.
لم يكتفوا بالاستمتاع بالصوت، بل ذهبوا ليعرفوا مصدره.
وحين التقوا بأبو خليل، رحّبوا به، وقدّروا له ما جاء به.
قال أحد الشيوخ:
إن لديك جوهرة، يا رجل، وصوت ديكك ليس عاديًا، نحن بحاجة إليه.
ومنذ ذلك اليوم، لم يكن صوت الديك مجرد عادة، بل صار رمزًا للاهتمام والتقدير.
أما أبو خليل، فابتسم أخيرًا، وشعر أن مجهوده لم يذهب سدًى.
رسالة القصة
القصة تعلمنا أن الاعتياد على النعمة دون إدراك قيمتها يجعلنا نفقدها يومًا بلا عودة.
أهل القرية عاشوا سنوات على صوت الديك، لكنه حين رحل اكتشفوا أنهم لم يعرفوا صاحبه، ولم يشكروه قط.
فصار الغياب درسًا قاسيًا: لا بد أن نُقدّر من يخدمنا في صمت، وأن نعترف بالفضل قبل أن نفتقده.
